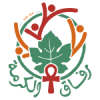بقلم الأب جاك ماسون اليسوعي
"إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى"
يعبّر هذا العنوان خيرَ تعبيرٍ عن جلّ إيماننا المسيحي بالكتب المقدسة إذ نعتبرها كلام الله مع اعترافنا بأن كتّابها من البشر. وقد يبدو الأمر بسيطاً ولكنه يضعنا فعلياً أمام عدة صعوبات. كيف نقول أن متى هو كاتب الإنجيل الذي يحمل اسمه وأن نؤكد في نفس الوقت أن هذا الكتاب هو "كلام الله"؟ فكيف يكون الكتاب الواحد عمل كاتبين؟ وكيف يحل لنا أن نقول أن كله لمتى وكله لله؟ ومع ذلك فإنها الطريقة الوحيدة الصحيحة لوصف الأسفار المقدسة!
1- الوحي
يرتكز إيماننا المسيحي على كشف الله لنا عن ذاته وإطلاعنا على قصده من الخليقة وبالأخص من الإنسان. وتقرّ جميع المذاهب المسيحية بوجود الوحي الإلهي أو كلام الله في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد.
ولهذا الإيمان بالوحي ميزة يتّسم بها التقليد المسيحي : فإن المبادرة تأتي من الله، إذن ليس الإيمان المسيحي ثمرة لاجتهاد الفكر البشري. وهنا نشارك في موقفنا هذا اليهود والمسلمين : فكتُُبُهم هم أيضاً يعتبرونها كلام الله ووحي منه. لكن ما يميز الكتاب المقدس هو أنه وحىٌ يمتد على نحو ألفي سنة من التاريخ فشهود هذا الوحي إذن كثيرون. ومن ثَمّ جاء الوحي الإلهي في صورة نصوص مختلفة العمر والثقافة، ومن خلال أشخاص مختلفي الطباع والأمزجة. ومع ذلك فاليهودي كالمسيحي يعتبران أسفار الكتاب المقدس المختلفة وحدةً فريدة ومتماسكة كشيءٍ واحد يعبّر عن إيمانٍ واحد. هذا الكل متماسك لأنه كلام الله!
2- الإلهام
يرتبط مفهوم الإلهام ارتباطاً وثيقاً بتعدد كُـتّاب الأسفار، بثقافاتهم وأساليبهم المختلفة. إن هذا التعدد وهذا التنوع يفرضان علينا الحديث عن هؤلاء الكُـتّاب. وحتى يتسنى لنا القول بأنهم ناقلي "كلمة الله" يجب أن نقول أولاً أن الله قد "ألهَمَهم" حتى يكتبوا ما أراد هو أن يكتبوه.
إن الإيمان المسيحي يرفض النظرة لأسفار الكتاب المقدس على إنها "منزلة"، فهي تختلف أسلوباً ولغةً ولابد من الحديث عن كُـتّاب بشريين تظهر شخصياتهم في أعمالهم. لابد من أن نقول إذن أن كلاً من هؤلاء الكُـتّاب ممن ساهموا في تدوين تلك الأسفار هم واضعوها بالمعنى التام للكمة من غير المساس بإلهامهم من قِبَل الله تعالى، فهم مُلهَمون لدرجة تتيح لنا القول أن كل سفر من أسفارهم هو "كلام الله" وأن الله هو "قائله".
ويأتي هذا الاقتناع من النصوص نفسها وبدءاً بالعهد القديم. فإن الله نفسه يتحدث على لسان الأنبياء (أشعياء 1: 2/6: 6-9، أرميا1 : 9، حزقيال3: 10 وما بعده، عبرانيين1:1)، ويكتب شريعته بيده (خروج 24 : 12، تثنية 4 : 13 / 10 : 4)، أو يُمْليها على موسى (خروج 24 : 4 ، تثنية 31 : 9). وهو الله أيضاً الذي يطلب تدوين مآثره حتى تبقى في ذاكرة شعبه (خروج 17 : 14، عدد 33 : 2). كما يعترف العهد الجديد بالعهد القديم ككلام الله (متى 15 : 6).
ويتضح هذا أكثر في رسالة بولس الثانية لتيموثاوس 3: 16 حيث يقول : «إن الكتاب بكل ما فيه، قد أوحي به الله»، كما يؤكد القديس بطرس : «إذ لم تأتِ نبوءة قط بإرادة بشرية، بل تكلم بالنبوءات جميعاً رجال الله مدفوعين بوحي الروح القدس» (2بط 1: 21)
وهكذا لم توضع مساهمة الكُـتّاب أو الأنبياء في الاعتبار بل ما تم التأكيد عليه هو مبادرة الله، والسبب واضح : فقد نقبل بسهولة فكرة أن هذا الكاتب أو غيره من البشر قد دوّن سفراً من أسفار الكتاب المقدس أما القول بأن الله هو الكاتب لتلك الأسفار فهذا شيء أقل وضوحاً. ولذا كان يجب التأكيد عليه مراراً.
لم يغيّر آباء الكنيسة هذه النظرة للنصوص المقدسة، كما لم يعنو بمساهمة الكُـتّاب أنفسهم لدى تدوينهم أعمالهم، بل اكتفوا بالتأكيد أن الكتب المقدسة هي "كلام الله". إلا أن فضل آباء الكنيسة مزدوج : فمن ناحية اعتبروا جميع الكتب التي تتحدث عن يسوع – نصوص العهد الرسوليّ – نصوصاً ملهمةً هي الأخرى بما أن يسوع يتمم ما جاء في الكتب ليصبح الله هو كاتب جميع الأسفار سواء في العهد القديم أو الجديد. ومن ناحيةٍ أخرى استخدم آباء الكنيسة تشبيهين في معرض حديثهم عن الإلهام، التشبيه الأول هو تشبيه الإملاء : (أوصا بيوس، تاريخ الكنيسة 5 ، 28 ، 18 ، إيرونيموس، الرسالة 120، مجموعة الآباء اللاتين 22 : 997 و34:1070) أما التشبيه الثاني فهو تشبيه الآلة الموسيقية : «استخدم الروح كما ينفخ عازف الناي في نايه» (أثيناغورس، دفاع عن المسيحيين 7 : 9، مجموعة الآباء اليونانيين 6، 904، 908).
ولم تأتِ العصور الوسطى بجديد في هذا الصدد. ولكن دبّت الحركة في كنيسة الغرب في عصر النهضة في القرن السابع عشر بظهور نقد الكتاب المقدس. ولا ننسى أن النهضة كانت منذ بدايتها حركةً "إنسانية" أي أنها سلّطت النظر على الإنسان في المقام الأول بعكس العصور الوسطى التي سلّطت النظر على الله.
ولذلك كان بديهياً أن يوجّه عصر النهضة نظره لا على الله ككاتب للنصوص المقدسة بل على الإنسان الذي أمسك بالقلم ودوّن. وقد أدى اكتشاف دور الكُـتّاب البشريين إلى لفت الانتباه لطبيعة بيئاتهم الثقافية العتيقة أو رؤيتهم للعالم مما أدى إلى حدوث أزمة خطيرة في لاهوت الوحي والإلهام : فـ "أي من الكلام هو كلام الله وأي من الكلام هو كلام الإنسان؟" وكان الاختلاف في أسلوب الكتابة والتعدد في وجهات نظر الكُـتّاب هما الدافع إلى الاعتراف بمساهمة الإنسان في كتابة الأسفار المقدسة. فكيف نقول إذن أنها كلام الله؟
هنا تلاشت نظرة الصفة الإلهية البحتة للكتب المقدسة والتي تصور الله يُمْلي بكلامه كلمة بكلمة على الإنسان إذ أنها لم تضع في اعتبارها دور الإنسان الحقيقي ككاتبٍ لها. وإذا بموقف عالِم اللاهوت من الإلهام في الكتب المقدسة كموقف الفيلسوف من مسألة الحرية : "إما أن يكون الله هو القدير على كل شيء ويفقد الإنسان حريته أو أن يكون الإنسان حراً ويفقد الله قدرته المطلقة".
ولكن لابد من العبور من "المنافسة إلى "التعاون" ولن يتحقق هذا إلا عن طريق "الشركة"، فإن المنافسة تجعلك تعتبر ما يُعطَى للواحد مسلوباً من الآخر وإذا أعطَيتَ كل شيء للهِ لم تترك شيئاً للإنسان وإن أعطَيتَ شيئاً للإنسان أخذتَه من الله. هكذا لن يصل عالِم اللاهوت لشيء مع هذه الرؤية.
أما على صعيد "التعاون" و"الشركة" فبوسعنا تخطّي التعارض، لأنه عندما يتحد كائنان لدرجة أن يصبحا واحداً يمكننا القول أن عملاً ما هو كله من صنع الأول وهو أيضاً كله من صنع الثاني.
إن الإلهام هو هذه النعمة الإلهية الخاصة التي تتيح للإنسان أن يكون ذاته في نفس الوقت الذي يجعل الله منه أداته المفضلة إلى حد اعتبار عمل هذا الإنسان هو أيضاً عمل الله. عندئذٍ تكون الشركة بينهما كاملةً ومطلقة.
وهنا نصل إلى الصيغة التي وضعها المجمع الفاتيكاني الثاني في تعبيره عن "الوحي" : «إن الله اختار لصياغة الكتب المقدسة أناساً في كمال إمكاناتهم ووسائلهم، واستخدمهم لكي – بعمله فيهم وبواسطتهم – يدوّنوا كمؤلفين حقيقيين كل ما يريده، وما يريده فقط" (المجمع الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي في الوحي الإلهي، رقم 11.)
هكذا يؤكد اللاهوت الكاثوليكي أن الله هو كاتب الأسفار المقدسة بأسرها وأن الكُـتّاب البشريين لهذه الأسفار هم كُـتّابها في نفس الوقت "مستخدمين كمال إمكاناتهم ووسائلهم". وفي هذا تشابه مع تعاليم الخليقة : «الله هو الذي يعمل كل شيء، والطبيعة أيضاً تعمل كل شيء». إنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ الاثنين : وجود الله وعمله في الخليقة من جانب، وحرية الإنسان والطبيعة من جانبٍ آخر.
وبالرغم من صعوبة فهم هذا الكلام إلا أنه يجب التأكيد عليه وإن كان متناقضاً لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ الله والإنسان. إذن كل شيء يأتي من الله وكل شيء يأتي من الإنسان فيما يتعلق بالكتاب المقدس.
لقد مرت كنيسة الغرب بأزمة قاسية مكّنتها في النهاية من تحقيق تقدم ملموس في التعبير اللاهوتي عن "الإلهام" و"الوحي"، بينما لم تمر كنيسة الشرق بنفس الأزمة ولا تزال تتبع تعاليم آباء الكنيسة إذ تعتبر الوحي كلمات أمْلاها الله على كُـتّاب الأسفار. هذا ما نجده في كتب التربية الدينية المدرسية.
3- "حقيقة" أو "عصمة" الكتب المقدسة
إن الإيمان بالوحي في الكتب المقدسة هو الذي يجعل منها مرجعاً أكيداً للحياة المسيحية. ولما كانت الكتب المقدسة مُلهَمةً من الروح فهي إذن تقدّم الحقيقة ولا تتحمل الخطأ. فلا يمكن لله أن يُخدَع أو أن يخدعنا.
وفي هذا لم يضع آباء الكنيسة نظريات موسعة بل اكتفوا بتوضيح بعض التناقضات الموجودة بين العهدين أو بين الأناجيل الأربعة على الأكثر. إنهم وبكل بساطة لم يقبلوا فكرة احتواء الكتاب المقدس على أخطاء أياً كانت طبيعتها : إنه كتابٌ "معصومٌ" عن الخطأ.
هنا أيضاً أخذ التقدم العلمي في عصر النهضة يطرح التساؤلات في شأن هذه "العصمة". ونشأ النزاع بخصوص العلوم الطبيعية فالكل يعرف موضوع جاليليو (1564 – 1642) والقضية التي رفعتها ضده الكنيسة يوم أعلن أن الشمس لا تدور حول الأرض بل أن الأرض هي التي تدور حول الشمس.
قد تسبب ذلك في التشكيك في صحة كلام الكتاب المقدس فيما يتعلق بيشوع بن نون قد تسبب ذلك في التشكيك في صحة كلام الكتاب المقدس في ما يتعلق بيشوع بن نون الذي أوقف دوران الشمس (يشوع 10 : 12) ومع ذلك لم تكن تلك إلا البداية، لقد أخذَت الصعوبات تنمو وتتكاثر من أصغرها (ليس الأرنب من الحيوانات المجترة كما جاء في سفر اللاويين 11 : 6 وتثنية الاشتراع 14 : 7) إلى أكبرها. وماذا يتبقى بعد نظرية داروين ونظرية تعددية الأصل البشري (polygénisme ) من قصة الخليقة والخطيئة الأولى إذا اعتبرناها قصصاً تتضمن حقائق تاريخية أو علمية ؟
و عن ردود الأفعال إزاء هذه الصعوبات كان هناك نوعان
· فإما أن ينحني العلم أمام ما تقوله الكتب المقدسة (قضية جاليليو)
· إما أن يتم إثبات التوافق بين ما تقوله الكتب المقدسة وما تقوله النظريات العلمية الحديثة. وهناك أمثلة كثيرة على هذا "التوافق" في كتب التربية الدينية المدرسية (انظر كتاب أولى ثانوي 95 -96 صفحة 13 – 16) أو مقالات الأنبا بولا بمجلة "الكرازات" سنة 1995. وهناك مِثل هذا الاتجاه عند الإسلام إذ يدّعي المفسرون اكتشاف اتفاقاً تاماً بين ما جاء في القرآن وما تأتي به العلوم الحديثة.
على أن المحاولتين لم يأتيان بأية نتيجة فهما لم تتوّصلا إلى فهم طبيعة الكتاب المقدس أو مضمون تعاليمه.
إنه من الحكمة هنا أن نعود لمقولة القديس أغسطينوس : «لم يشأ الروح القدس أن يلّقن البشر هذه الأمور التي ليس فيها أية فائدة للخلاص» (تفسير سفر التكوين حرفياً 2 ، 9 ، 20، مجموعة الآباء اللاتين 34 : 270)، أو مقولته : «لم يرد في الإنجيل أن قال الرب ذات يوم: سأرسل إليكم الروح المعزّي ليعلمكم دوران الشمس والقمر؟ لأن قصده إنما كان تكوين مسيحيين لا علماء رياضة» (القديس أغسطينوس ضد فيليكس 1 : 10).
وامتد أجل الأزمة وقتئذٍ إذ كان لابد من أن تأخذ الكنيسة وقتها قبل فتح أبوابها أمام الأبحاث العلمية والتاريخية، القرار الذي لم تأخذه إلا في منتصف القرن العشرين حين شجّع البابا بيوس الثاني عشر علماء الكتاب المقدس على دراسة الأساليب الأدبية المستخدمة في عصور تدوين النصوص المقدسة.
وكانت النتيجة وضع المجمع الفاتيكاني الثاني للـ"دستور العقائدي في الوحي" الذي استبدل لغة الدفاع ضيقة الأفق عن عصمة الكتب المقدسة (خلوها من الخطأ) بلغةٍ أكثر إيجابية هي لغة "الحقيقة". في نفس الوقت أدت النظرة الفلسفية لمفهوم "الحقيقة" إلى تصنيفها حسب موقفها النسبي من الخلاص، فهناك "الحقيقة العلمية" و "الحقيقة الفنية" و "الحقيقة الأخلاقية"... إلخ.
«تعلمنا أسفار الكتاب المقدس بثبات وأمانة وبعيداً عن الخطأ الحقائق التي أراد الله تسجيلها في الكتب المقدسة» (المجمع الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي في الوحي، رقم 11).
تتعلق الحقيقة في الكتاب المقدس بسبل الخلاص. فكما قال القديس بولس : «الكتب المقدسة قادرة على أن تزودك بالحكمة التي تهدي إلى الخلاص» (2 تيم 3 : 15)، إذن ليس هناك مجال للمنافسة بين الحقيقة في الكتاب المقدس والحقائق الأخرى كالحقائق العلمية، إذ ليست الأولى من نوع الثانية بل هي حقيقة لاهوتية وروحية.
يقدم لنا الكتاب المقدس الحقيقة لأنه يعلمنا ما نحتاج إليه حتى نعيش العلاقة مع الله، تلك التي يجب أن تقودنا على دروب الحقيقة في هذه الحياة، وترشدنا إلى الحياة الأبدية.
فليس غرض سفر التكوين أن يلقننا دروساً في تاريخ نشأة العالم بل أن يعلمنا أن البداية من الله، وأن ما خلقه الله حسن، وأن الإنسان خُلِق على صورة الله وأن الشر لم يأتِ من الله. فمقصد سفر التكوين إذن ليس علمياً أو تاريخياً بل لاهوتياً. فإن كان كاتبه قد كتب ما كتب متأثراً بثقافة عصره فهذا طبيعي ومن الصعب أن يكون غير ذلك.
أما الأناجيل فليس هدفها أن تنقل لنا تفاصيل حياة يسوع بل هدفها الأساسي هو إطلاعنا على رسالته الخلاصية. لقد أراد كل من الإنجيليين – بإلهام من الروح القدس – التأكيد على ملامح معينة من شخصية يسوع دون سواها، أو على قيمة معينة لرسالته دون غيرها. فهم يختلفون فيما بينهم إذ أنهم شهود للروح القدس أكثر منهم شهود للتاريخ. وكم من صعوبة تزول لو لم نطالبهم بما لم يقصدوا نقله إلينا.
وختاماً من الأنسب أن نعود إلى "الوحي" لنلاحظ شيئاً : لا يقال عن أحد الأسفار المقدسة أنه وحي من الروح المقدس بسبب ما جاء فيه من قِبَل شخصٍ ما أو رسولٍ من الرسل بل هي الكنيسة التي تقرّ بذلك – الكنيسة أي شعب المؤمنين الذين يجدون طريقهم فيه فيعترفون ويقرّون : "في هذه الكتب وحيٌ من روح الله".
أما الكاتب فمن الجائز أن يكون واع بوحي الروح كحال كُـتّاب العهد القديم الذين دوّنوا في نهاية نصوصهم "كلام الله". ولكن ليس هذا ضرورياً لأنه ليس كل الكُـتّاب واعين بوحي الروح وهناك مثل القديس بولس الذي كتب : «وأما العزّاب، فليس عندي لهم وصية خاصة من الرب، ولكني أعطي رأياً باعتباري نلت رحمـة ً من الرب لأكون جديراً بالثقة». (1 كو 7 : 25).